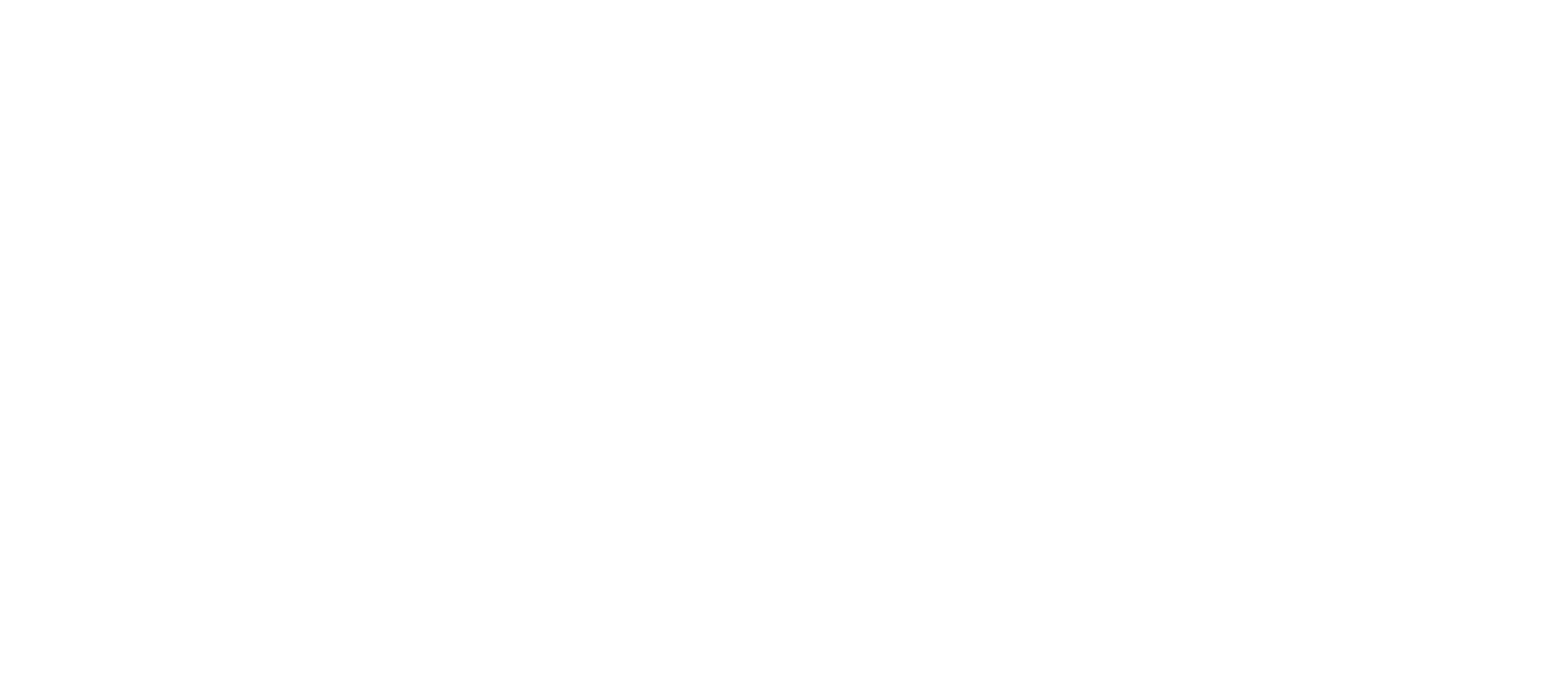الوزارة “قطعت الحبل” بالطلاب النازحين

كتبت زينب حمود في “الأخبار”:
قبل أكثر من شهر، دعت وزارة التربية الطلاب النازحين من المناطق الحدودية إلى الالتحاق بالمدارس والثانويات الرسمية القريبة من أماكن نزوحهم، من دون مواكبتهم على المستوييْن التربوي والنفسي. وكانت النتيجة على قدر التوقّعات: امتناع عدد من النازحين قسراً عن مواكبة التعليم لأسباب: لوجستية، كغياب الكتب المدرسية، ونفسية ترتبط بظروف التهجير، وأخرى تتعلق باختلاف نظام التعليم بين مدرسة وأخرى.
لم يهضم كثيرون من الأهالي التحاق أبنائهم بالتعليم عن بعد أو اللجوء إلى مدرسة قريبة من مكان سكنهم المؤقّت، لأنها «فترة وبتقطع»، وفق حسن الذي لم يحضر حقيبة الكتب لابنه عندما نزح من عيتا الشعب إلى برج رحال في مدينة صور، إذ إن الأوضاع المعيشية الصعبة وظروف حياة عدد من العائلات المهجّرة تجعل الأولوية لتأمين سكن آمن ومستلزمات العيش بعدما تعطّلت أعمالهم، وتجعل التعليم «ترفاً»، لأن «ظروف حياتنا في منزل أقاربنا ووضعنا النفسي لا تسمح بالتفكير في التعليم». فيما جرّب آخرون التحاق أبنائهم بمدارس قريبة من أماكن نزوحهم، لكنّ هؤلاء لم يتقبّلوا التجربة، لعدم تمكّنهم من الاندماج في مدرسة جديدة، ووسط أساتذة وتلامذة جدد. وهذا شكل من أشكال التسرّب المدرسي الذي تحذّر المتخصّصة في علم النفس التربوي أميمة عليق من «مخاطره، وإن كان مؤقّتاً، لأنه قد يدفع ببعض التلامذة وخصوصاً من الفئات العمرية المتوسطة إلى سوق العمل، فتغريهم الاستقلالية المادية ويتوقّفون نهائياً عن التعليم، فضلاً عن الحاجة إلى تعويض الفاقد التعليمي، الذي يقع غالباً على عاتق العائلات».
يتحمّل التلامذة الجنوبيون التبعات النفسية والتربوية لقرار وزير التربية الذي تعاطى معهم كـ«باكيج» واحدة، متجاوزاً ظروفهم المعيشية والنفسية التي تختلف بين تلميذ وآخر، فضلاً عن أن القرار جاء كـ«رفع عتب»، إذ لم يترافق مع تتبُّع وُجهَة التلامذة النازحين للتأكد من التحاقهم فعلاً بمدارس أخرى، ولم يتقصَّ أوضاع «الملتحقين» النفسية والتربوية المتأثّرة بالدرجة الأولى بظروف التهجير. وقد لحظت الهيئة الصحية الإسلامية، خلال جولتها على عدد من المدارس في صور والنبطية حيث العدد الأكبر من النازحين من القرى الحدودية، ضمن برنامج الطوارئ العام، «الأثر النفسي جراء تغيير نظام التعليم، ما استدعى إحالة عدد من الحالات إلى المراكز والعيادات النفسية بعد ظهور سلوكيات مثل التبوّل اللاإرادي وفرط الحركة وغيرهما»، بحسب مسؤولة دائرة التثقيف النفسي في الهيئة زينب قاسم.
إلى الأثر النفسي، يقع على عاتق المهجّرين أيضاً تذليل العقبات أمام مواصلة تعليم أولادهم، بدءاً من تأمين الكتب المدرسية التي تختلف عن تلك الموجودة في حوزتهم وتحمّل تكاليفها، ومواكبة المسيرة التعليمية في مدرسة تختلف في منهاجها وأساليب الشرح والأدوات وتقسيم الفصول وتراتبيتها عن المدرسة التي نزحوا منها. علماً أنّ تغيير المدرسة بشكل عام يترك أثراً نفسياً وتربوياً لدى الطلاب، فضلاً عن دخول التلامذة النازحين صفوفاً اجتازت دروساً لم تمرّ عليهم، ما صعّب المواكبة، وزاد عبء التعويض عن الفاقد التعليمي.
ومع «نفض» وزارة التربية «يدها» من مساندة التلامذة النازحين نفسياً وتربوياً، يتوقف مصير هؤلاء على إنسانية إدارات المدارس التي تستقبلهم وأساتذتها، إذ إن هناك من يقوم فعلاً بجهد كبير لتمكين التلامذة النازحين من الاندماج في صفوفهم وتذليل العقبات أمامهم وتعويض ما فاتهم. وتلفت علّيق في السياق إلى ضرورة «تجنّب أسلوب الشفقة أو تمييز الوافدين، وفي الوقت نفسه عدم تجاهل وجودهم أو التذمّر والتململ من الجهد الإضافي الذي فرضه حضورهم».